لعلَّك جربت مرَّات قليلة أو كثيرة خلال حياتك أن تواجه صعوبة مُعيَّنة وأنت تحاول تعلُّم شيء جديد، فربَّما أحسستَ أنك بطيء جداً في حل مسائل الرياضيات، أو أنَّك غير قادر على استيعاب طريقة عمل آلة من الآلات، أو أنَّك لا تجيدُ الفوز في لُعبة حاسوب. ولو حاولتَ مُمارسة أيَّة واحدة من هذه المهام وتكرارها عدداً من المرَّات فلا بُدَّ وأن أدائك فيها سيتحسَّن، فستتمكَّن من الوصول في لعبتك إلى مراحل متقدِّمة أكثر، وستنجح في حل المسائل الرياضية بسُرعة أكثر، لكن هل هذا كافٍ؟ إلى أيِّ درجة يمكنك إتقان مهارة في الحياة بمُجرَّد تكرارها عدداً كبيراً من المرَّات؟ يقول مثل إنكليزي مشهور: «Practice makes perfect»، لكنها على كثرة تكرارها قد لا يكون صحيحةً بالضرورة، فالمسألة -في الواقع- أعقدُ بقليل من ذلك.

المستوى الجامعي
صادفتُ منذ مدَّة مقالة تنتقدُ نظام التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية وتدعو إلى إعادة هيكلته ليفتح مجالاً أكبر لإبراز مواهب الطلاب صغار السِّن، والتي – كما يرى كاتب المقال – تضيع الكثير منها في مرحلة مُبكِّرة دون تنمية وتطوير. وكانت التعليقات التي كتبها قُرَّاء المقالة مثيرة للاهتمام، وجذب أحدها انتباهي على وجهٍ خاص يروي قصَّة لصاحب التعليق، يقول فيها: «مرَّة عندما كنتُ في الصف الرابع الابتدائي، طلب منا أستاذ اللغة الإنكليزية كتابة قطعة نثريَّة صغيرة ضمن فروضنا المنزليَّة. عندما أنهيت كتابة قطعتي وسلَّمتها لأستاذ المادَّة للتصحيح انبهر بأسلوبي في الكتابة، فأرسلني على الفور إلى مدير المدرسة، وأُعْجِبَ هذا بما كتبتُه إعجاباً جماً لدرجة أنه كرَّمني ومنحني شهادة تقديريَّة، قائلاً لي أنَّي كنتُ أجيد الكتابة باللغة الإنكليزية بـ”مستوى طلبة الجامعات”». لكنَّ صاحب التعليق يُتابع القصة: «ثم مرَّت السنوات، وأصبحتُ طالباً في الجامعة. ففوجئتُ بأنَّ الجميع أصبحوا الآن قادرين على الكتابة باللغة الإنكليزية بمستوى طلبة الجامعات».
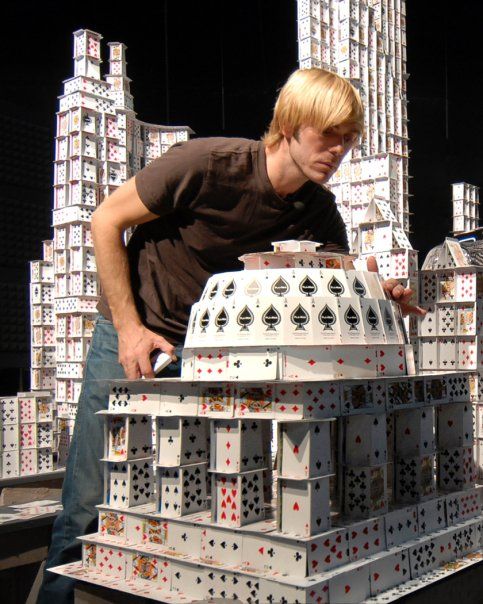
وتُعبِّر هذه القصة المرحة عن واقعٍ جوهري، فلو كانت الموهبة الفطريَّة سبباً كافياً لتحقيق النجاح، لما اضطرَّ ذلك الفتى إلى ممارسة الكتابة على الإطلاق منذ تخرُّّجه من المدرسة الابتدائية، وكان سيُصبح – بالرُّغم من ذلك – كاتباً مهماً. لكن من الواضح أنَّ نقص الممارسة المُنظمة ربما يقضي على الكثير من المواهب الطبيعيَّة قبل أن تنال فرصتها لتبرز، فعلى سبيل المثال، من الواضح أن ألبرت آينشتاين لم يولد وهو قادر على كتابة معادلات الطاقة النووية، ومن المؤكَّد أنَّ ثوماس أديسون لم يكن يعرف كيفيَّة صُنع آلاتٍ كهربائية مُعقَّدة وهو طفلٌ في السَّابعة. مهما كانت الموهبة الطبيعيَّة قوية فهي ليست كافيةً وحدها لجعل أي شخصٍ في العالم عبقرياً. وتبقى الممارسة والخبرة والتدرب والعمل الشاق أسباباً جوهريَّة في نجاح الناس كافة، مهما كانت قدراتهم الطبيعية تبدو متفوِّقة على الآخرين.
لكن، ما هي أهميَّة الموهبة في النجاح والإنجازات التي يذكرُ بها الناس؟ الإجابة على هذا السؤال -في الحقيقة- ليست سهلةً على الإطلاق. فمُعظم الأشخاص الناجحين قضوا سنوات كثيرة وساعات طويلة من حياتهم في صقل مواهبهم قبل أن ينالوا نجاحاً فيها، فقد كان الروائي الأمريكي هرمان ملفل -مثلاً- يُكافح لعشرات السنين في بيع كتبه، إلا أنَّ اسمه لم يشتهر إلا بعد سنين من وفاته (حينما أثارت روايته «موبي دك» اهتمام العديد من النقاد الأدبيِّين في أمريكا واكتسبت شهرة هائلة لتبيع ملايين النُّسخ)، ومع أنَّك قد تعتبر آينشتاين واحداً من أكبر عباقرة الفيزياء في التاريخ، إلا أنَّ درجاته بمادة الرياضيات في المدرسة كانت عاديَّة جداً، ولو اضطرَّ للعمل في مجال بعيد عن الفيزياء فكان من المحتمل ألا يعرف أحدٌ بموهبته قط. من جهةٍ أخرى، توجد قصصٌ كثيرة عن علماء أبدوا نبوغاً وعبقريَّة منذ مراحل مبكرة في طفولتهم، ومن هنا يقع الخلاف الأزلي بين الموهبة والممارسة.
قاعدة الـ10,000 ساعة

بدأت دراسة المنافسة بين الموهبة والممارسة الطويلة منذ أمد بعيد، إذ وضع الفيلسوف الإنكليزي جون لوك مقالةً فيما سمَّاه «الحالة الافتراضية» منذ سنة 1690، والتي يزعم فيها أن جميع الناس يُولدون بمستوى مماثلٍ من الإدراك والقدرات، ولا يتغيرون بعد ذلك إلا وفقاً للظروف والبيئة المحيطة بهم. ونوقشت هذه الفكرة مراراً ومن منطلقات فلسفية عدّة على مر القرون التالية، وبدأت تخضع للبحث العلمي منذ منتصف القرن الماضي. نشر عالم النفس وصاحب جائزة نوبل في الأدب هربرت سايمون نتائج بحث مهم عن لاعبي الشطرنجفي سنة 1973، أظهر فيه أنَّ فئة النخبة من لاعبي الشطرنج يحتاجون إلى استخدام 50,000 وحدة ذاكرة ليستطيعوا اللعب مع خصومٍ محترفين، وهي مقدرة لا يستطيع الدماغ البشري اكتسابها إلا بمُمارسة مُكثَّفة طويلة الأمد. أظهرت بحوث أخرى أن قدرة الدماغ والذاكرة طويلة الأمد على استرجاع المعلومات بسُرعة وكفاءة لها دور أساسي في التفوّق بمجالات كثيرة، وأنَّ هذا التطور يترافقُ مع ساعاتٍ طويلةٍ من التدريب.
في سنة 2008 أصدر صحفيُّ كندي يدعى مالكولم غلادول كتاباً ذائع الصيت باسم Outliers: The Story of Success يستعرض فيه قصص نجاح عدد من الشخصيَّات الشهيرة في تاريخ الإنسانية، مثل بل غيتس وفرقة البيتلز البريطانية، ويُحاول دراسة العوامل التي قادتها إلى تحقيق إنجازاتها. وتلقّى الكتاب شيئاً من النقد لأسلوبه غير العلميّ في تناول بعض الأمور وبناء استنتاجات ساذجة عليها أحياناً، إلا أنَّه اكتسب شهرة كبيرة في وقت قصير، فقد تصدَّر قمَّة قائمة الأعمال الأكثر مبيعاً لصحيفة النيويورك تايمز لمُدَّة ثلاثة شهورٍ متتالية، ولعلَّه ساهم بتوجيه اهتمام الباحثين وعامة الناس نحو مسألة المهارة والإبداع في السنوات الأخيرة. كانت واحدة من النظريات المثيرة للاهتمام التي جلب الكتابُ لها الشهرةَ ما يُسمَّى «قاعدة الـ10,000 ساعة»، لكن فكرة هذه القاعدة تعود -في الواقع- إلى دراسة علمية نشرت في سنة 1993.
تزعم قاعدة العشرة آلاف ساعة أنَّه، عندما يحاول أي شخصٍ في العالم اكتساب مهارة من نوعٍ ما، عليه التدرب عليها لمُدَّة لا تقل عن ثلاث ساعاتٍ يومياً على مدى عشر سنوات متتالية حتى يتقنها إلى درجة الاحتراف، أي بعبارة أخرى، عليه أن يصرف عشرة آلاف ساعة من حياته بمُمارستها مرَّة تلو الأخرى. حسبما تنصُّ القاعدة، ليس من الضروري أن يُصبح كل شخصٍ يصرف عشرة آلاف ساعة من حياته في التدريب على شيء مُعيَّن مشهوراً أو ذائع الصيت في مجاله، لكن جميع من حقَّقوا هذه الشُّهرة التزموا – حسبما تدعي النظرية – بهذا المقدار من التدريب كحدٍّ أدنى.

ظهرت فكرة قاعدة العشرة آلاف ساعة في بداية التسعينيات، عندما بدأ فريقٌ من علماء النفس في برلين بإجراء دراسة على عازفي الكمان المحترفين في عدة فرق أوركسترا ألمانية معروفَة، وتوجَّه الباحثون إلى هلاء العازفين وسألوهم: «منذ طفولتكم، وحتى أصبحتم عازفين معتبرين في هذه الفرق، ما هو عدد الساعات التي قضيتموها بالتدرب على العزف كل يوم؟». أجريت الدراسة تحت قيادة أندريس إريكسون، وهو باحث سويدي مشهور بعمله الرائد في مجال جديد في علم النفس يتعلَّق اكتساب الخبرة والمهارة، ويُسمَّى “Expertise Studies”، وقد نُشِرَت دراسته في سنة 1993، تحت اسم The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance، وتعني «دور الممارسة المُكثَّفة في اكتساب الأداء الاحترافي». اعتمدت الدراسة على مقارنة الوقت الذي يُقدِّر عازفو الكمان أنهم صرفوه بالتدرُّب منذ طفولتهم مع مستوى أدائهم الفعليّ، فوجدت أنَّ مُعظمهم بدؤوا مُمارسة العزف وهم في عامهم الخامس، واستمروا بالعزف لعددٍ مماثلٍ من الساعات أسبوعياً (وهو حوالي ساعتين إلى ثلاث ساعات) حتى بلغوا الثامنة. لكن الأوقات التي يخصِّصونها للتدريب اختلفت كثيراً منذئذٍ، ويختلف معها مستوى أدائهم سلباً أو إيجاباً. فالأفضل أداءً في سنوات شبابهم كانوا يعفزون لست ساعات أسبوعياً في عُمر التاسعة، ولثماني ساعات في الثانية عشرة، ولـ16 ساعة بعُمر الرابعة عشرة، فأكملوا عشرة آلاف ساعة من التدريب مع بلوغ عامهم العشرين. ولا تقتصر هذه الساعات على المُمارسة البحتة للعزف، بل هي تشمل – بدرجة ما – كل الأنشطة المُتعلِّقة بالتعلم، مثل الاستماع إلى الموسيقى وقراءة النوتات ومناقشة المادة مع أشخاصٍ آخرين.
كان مستوى مهارة كلّ العازفين الذين تضمَّنتهم الدراسة متوافقاً تماماً مع عدد الساعات قضوها بالتدريب، ولم يلحظ الباحثون اختلافاتٍ ذات قيمة بين العازفين لأن بعضهم لديهم “موهبة طبيعيَّة” استثنائية. فمثلاً، كانت المدة التي صرفها أصحاب الأداء الـ”متوسط” في التدريب على مرّ حياتهم حوالي ست آلاف ساعة، وأما من كان أداؤهم “ضعيفاً” فتدرَّبوا لأقل من ألفي ساعة، وهكذا. والنتيجة حسبما زعمت الدراسة أنَّه لا وجود لموهبة فطرية تحكم قدرات الناس في العزف، بل إن نجاح العازفين في مهنتهم يرجع – بالغالبية العُظمى منه – إلى طول الوقت الذي استثمروه في مُمارسة ألحانهم.
أظهرت دراسة أندريس إريكسون أنَّ الناس قد يتجاوز نقصهم في مهارات مُعيَّنة (بل واكتساب قدرات جديدة) بمُجرَّد ممارستها لفترات طويلة. قد تكون -مثلاً- ذاكرة أحد لاعبي الشطرنج ضعيفة أو بديهة أحد العازفين بطيئة بحيث لا تساعده على العزف بسرعة، إلا أنهما قادران على تجاوز هذه الأنواع من النقص بالتدريب الطويل. ويقول إريكسون أن ثمة عوامل أخرى تؤثر على احتراف العازفين لعملهم، مثل التشجيع من عائلتهم وأصدقائهم ومثل حافزهم الذاتيّ للاستمرار وعدم تعرُّضهم لإصابات أو عوائق مشابهة، إلا أنَّ إريكسون أصرَّ على أن مدة التدريب هي العامل الحاسم والنهائي في تحديد درجة مهارة العازفين، وقدَّم نتائج تُدلِّل – بدرجة أو بأخرى – على ذلك الادعاء.
نالت دراسة أندريس إريكسون شعبيَّة كبيرة في المُجتمع العلمي وبين عامة الناس على حدِّ سواء، فقد حظيت بأكثر من 4,200 استشهاد في أوراقٍ علميَّة منشورة وذاع في صيتها على الإنترنت وفي الكُتب، خصوصاً بعد أن ذكرها مالكوم غلادول مراراً في كتاب Outliers. ويُمكن القول أن عدداً معقولاً من الباحثين والكتاب في مجال علم النفس اعتبروا قاعدة العشرة آلاف ساعة (أو السنوات العشر) أشبه بحقيقة علميَّة لفترةٍ جيدة بعد نشر دراسة إريكسون.
وجهة نظر العلم الحديث

عشرة آلاف ساعة هي مُدَّة كبيرة جداً من الوقت، فلو قضيت ثلاث ساعاتٍ يومياً بممارسة مهارة من المهارات ستستغرق عشر سنواتٍ كاملة في إتقانها. وقد يبدو من المنطقي أن أيَّ شخصٍ لا بُدَّ وأن يحترف مهارةً يقضي هذه المدة في ممارستها، لكن نتائج البحوث التي تبعت دراسة أندريس إريكسون منذ سنة 1993 لا تؤيد ذلك. ظلَّت فكرة العشرة آلاف ساعة التي طرحها أندريس قائمة لفترة من الزمن وحظيت بشعبيَّة عالية بين باحثي علم النفس لسنواتٍ عديدة، إلا أنَّها لم تعُد رائجة جداً في هذه الأيام، إذ توحي الكثير من الدراسات الحديثة بأنَّ العمل الشاق -رُغم أهميَّته الكبيرة- قد لا يكون سوى عامل واحد مؤثِّر في نجاح الناس، لكنه بعيدٌ عن أن يكون الحاسم بينها.
مع أنَّ الممارسة الطويلة ترفعُ الأداء بالتأكيد، لكنها قد لا تكون بديلاً كافياً عن الموهبة الفطرية (أو لعلَّ هذه الحال في أنواع مُعيَّنة من المجالات). جاءت الضربة الكبيرة لدراسة أندريس إريكسون، والتي غيَّرت وجهة نظر المجتمع العلمي حول موضوع الموهبة بدرجة كبيرة، حديثاً جداً، حين نُشرت في سنة 2014 دراسة تعاونيَّة بين باحثين في علم النفس من جامعات أمريكية عدَّة (منها جامعتا ميشيغان وبرونيل) تحت إشراف الأستاذ الجامعيّ ديفيد هامبرك. اعتمدت هذه الدراسة على مبدأ شبيه بدراسة إريكسون في التسعينات، فقارنت الأوقات التي صرفها عددٌ من لاعبي الشطرنج وعازفي الموسيقى والرياضيِّين والمدرسين بمُمارسة مهنهم مع مستوى إتقانهم لهذه المهن. لكن أعضاء الدراسة لم يحاولوا في هذه المرة استجواب الأشخاص الخاضعين لها، بل جمعوا عدداً كبيراً من الدراسات السابقة الموثَّة، يبلغُ عددها 88 ورقة بحثية صادرة عن جامعاتٍ مختلفة، وقارنوا نتائجها بعناية لاستخلاص ما يُمكن من أدلِّة منها. توصل الباحثون إلى أنَّ الدراسات السابقة لم تجد توافقاً بين عدد ساعات التدريب ومستوى الإتقان والمهارة إلا لحوالي 12% من الأشخاص، أما الـ88% الآخرون فلا يمكن تفسير مهاراتهم بناءً على التدريب، بل كان أداؤهم أعلى أو أقل بكثيرٍ من النتائج المتوقَّعة حسَبَ الأوقات التي قضوها في التدريب.
بصورةٍ عامة، تبيَّن أن تأثير التدريب طويل الأمد على المهارات التكرارية وثابتة الوتيرة (مثل الرياضة والسباحة) أعلى بكثيرٍ منه على المهارات التي يصعبُ توقّعها (مثل التعامل مع كارثة طيران). الأدهى من ذلك هو أنَّ تأثير ساعات التدريب على الأداء كان أعلى بنسبة كبيرة في الدراسات المعتمدة على التقدير (حينما يُقدِّر المشاركون المُدَّة التي كانوا يقضونها بالتدريب كل يوم) منه في الدراسات المعتمدة على السجلات اليوميَّة (والتي يُدوِّن فيها المشاركون فترات تدريبهم كلَّ يوم)، وبالتالي تغدو أدقّ بمقدارٍ معتبر. وعندما نحصرُ عينتنا في الدراسات التي دوَّن المُشاركون فيها يوميَّات دقيقة، لا تنجح نظرية العشرة آلاف ساعةٍ بتبرير إلا 5% من حالات النجاح والتميّز في مهارات محدّدة، بل أظهرت دراسة ديفيد هامبرك -كذلك- وُجود اختلاف لا يُستهان في عائد التدريب بين كل مهارة ومهارة أو مجال ومجال، ففي لعبة الشطرنج يتناسب أداء 26% من اللاعبين مع عدد الساعات التي أمضوها في ممارسة اللعبة، على أنَّ هذا الارتباط ليس قائماً إلا عند 21% من عازفي الموسيقى و18% من الرياضيين و4% من المُدرِّسين المتفرغين، كما يوضّح الرسم أدناه.

بحسب ما توصَّل إليه القائمون على هذه الدراسة، فإنَّ التدريب المُكثَّف ربما يلزمُ لتحقيق النجاح في حالات مُعيَّنة، لكن لو لم تكن لدى الشخص المؤهلات الكافية للنجاح في مجاله فإنَّ صرفَ عدد كبير من الساعات بالمُمارسة الشديدة قد لا يساعده كثيراً. من جهةٍ أخرى، تبيَّن أن بعض الأشخاص الاستثنائيين قادرون تحقيق أداء ممتاز بعدد قليل جداً من ساعات التدريب. وعليك أن تدرك -رغم هذه النتائج- أن هذه الدراسة تمكَّنت من رَبط 12% من حالات النجاح بالتدريب، لكنها لم تزعم أن النسبة الباقية عائدة إلى الموهبة المحضة أو الحمض النووي (DNA) وحده. فليسَ للموهبة تعريف دقيق متفقٌ عليه في المُجتمع العلمي حالياً، إلا أنَّ مُعظم الدراسات تميلُ الآن إلى وُجود عوامل كثيرة مُختلفة يُمكنها أن تؤثر على أداء الناس في مجالات ومهاراتٍ مُعيَّنة والتي لا يُمكن بحالٍ نسبُها جميعاً إلى الموهبة فقط، فمثلاً، للعُمر الذي يبدأ عنده الشخص تعلم مهارة مُعيَّنة أهميَّة كبيرة بسُرعة وجودة إتقانه لها، وثمَّة اختلافٌ لا يستهان به بين من يبدؤون تعلم عزف الموسيقى قبل الدخول إلى المدرسة ومن لا يمارسونها حتى عقد العشرينات. والتشجيع من العائلة والأصدقاء عاملٌ جوهري كذلك، فمن دونه لا يُمكن إلا لأشخاص قليلين ملاحقة شغفهم، وعدا عن ذلك فإنَّ الوُصوليَّة إلى مصادر التعلم والحصول على الفرصة للتدريب والنمو ومستوى الذكاء وقوة الشَّغف الذاتي والحصول على الإلهام بل والحظّ البحت كلُّها عوامل تؤثر على تحقيق النجاح في أيِّ مجالٍ من المجالات.
يظهر الرسم البياني أدناه العلاقة بين الموهبة والعمل الشاق في الأداء وفق دراسة ديفيد هامبرك. حسبما يُبيِّن الخط الأزرق الصاعد، يُمكن لبعض الأشخاص ودون أي تدريب مُسبَق أن يحققوا أداءً ممتازاً في مهارةٍ ما اعتماداً على موهبتهم الطبيعية وحدها، كما يدلُّ الرسم على أن من يبذل جهداً كبيراً لاكتساب مهارة من المهارات يصلُ إل مستوى ممتازٍ من الأداء فيها بالتدريب المستمر (حتى ولو نقصته “الموهبة”). وربّما يعني ذلك أن العمل الشاق، حتى لو لم يكن كافياً لتحقيق نجاح باهر في مجال ما أو وضعك في عداد نخبته، إلا أنَّه كفيلٌ بمنحك أداءً ممتازاً واحترافياً، كما يدلّ الرسم البياني على أنَّنا لو أخضعنا الناس كافة للتدريب الطويل والمُكثَّف فإنَّ الفارق بين أصحاب الموهبة الطبيعية ومن يفتقرون إليها يتقلَّص كثيراً. فمع أنَّ الشخص الذي يفتقر للموهبة ويمضي سنوات في العزف على الناي ربما لا يستطيع -طول حياته- الانضمام إلى فرقة أوركسترا عالمية، إلا أنَّه قد يُصبح عازفاً محترماً وقد يتمكَّن من عرض موهبته في مسارح صغيرة وأن يكتسب شهرة محلية جيِّدة.

نشر الصحفي والكاتب الأمريكي ديفيد إبستين في سنة 2013 كتاباً بعُنوان The Sports Gene انتقدَ فيه قاعدة العشرة آلاف ساعة وسائر أبحاث أندريس إريكسون في مجال الخبرة. يسير الكتاب على نفس نهج Outliers (الصَّادر قبله بخمس سنوات)، حيث يستعرض قصَص حالات نجاح مشهورة واحدة تلو الأخرى ليدعم استنتاجاته، لكن في هذه المرة وعوضاً عن تناول قصص أشخاصٍ قضوا سنوات طويلة في التدريب يتحدث إبستين عن رياضيِّين حقّقوا نتائج مُبهرة في بعض المنافسات دون أي تدريب مُسبَق يذكر. مع أنَّ إبستين يُقدِّم وجهة نظر مُتطرِّفة قليلاً اتجاه الموهبة في كتابه، إلا أنَّ طرحه – عند التغاضي عن تلك المبالغة – متوافق إجمالاً مع التوجُّه الحديث في الأبحاث العلميَّة نحو اكتساب الخبرة، والتي لم تعد ترى الممارسة المُكثَّفة عنصراً وحيداً في النجاح.
ما هي النتيجة؟
لم يَعد في المجتمع العلمي قبولٌ كبيرٌ -حالياً- لفكرة قاعدة العشرة آلاف ساعة، فعوضاً عن اعتبارها “قاعدة” مُطلقة أو سائدة أصبحت تعامَل مثل “احتماليَّة”. إذا جلبتَ مثلاً مجموعة عشوائية من الناس وطلبتَ منهم التدرب على مهارة مُعيَّنة، كالعزف على البيانو، فالإحصاءات تتوقَّع أن معدَّل الوقت الذي يستغرقهم لاحتراف العزف سيكون نحو 10,000 ساعة من التدريب، إلا أنَّ هذا الرقم (ورغم كونه وسطياً) لن ينطبق إلا على عيِّنة محدودة من الناس وقد لا يعني شيئاً للكثير منهم، فربّما يتقنون العزف في وقتٍ أقصر أو ربّما لا تقنونه أبداً، وقد اعترف بذلك أندريس إريكسون نفسه في بحث جديد له قائلاً: «ما من شيء مُميَّز بالذات في رقم العشرة آلاف ساعة». فالحقيقة المؤسفة، كما وصفها عالم النفس ستيفن بانكر، هي: «فكرة أن جميع الناس يُولدون متساوين في قدراتهم، قد اندثرت منذ زمنٍ بعيد»، وحتى لو تدرَّب الجميع بنفس المقدار وبالجُهد ذاته، فسينتهون بقدراتٍ مختلفة جذرياً.

إذاً ما الذي يؤثر على اكتساب الناس للمهارة أيضاً؟ على أرض الواقع، لا أحد يعرف تماماً. ممَّا لا شك فيه أنَّ ما يُسمِّيه الناس “الموهبة” أو “الجينات” عاملٌ جوهريٌّ في النجاح والإبداع، لكن فهم العلم للموهبة لا زال قليلاً جداً. يُعرِّف بعض الباحثين الموهبة بأنَّها «مجموعة من الصفات الشخصيَّة التي تساعدنا على إتقان مهارة ما بطريقة أفضل من باقي الناس»، لكن عدد هذه الصفات كبير جداً وطريقة تفاعلها مع بعضها مُعقَّدة بحيث يستحيل فصلها وتقصيها في دراسة علميَّة. فما يُهم ليس الصفات الفرديَّة التي تصنع الموهبة (كالذاكرة القوية أو البديهة السَّريعة أو الاستيعاب الجيِّد)، وإنَّما الناتج النهائي عن تفاعل كل هذه الصفات مع بعضها لدى شخصٍ مُعيَّن، ومن المحتمل ألا تتطوَّر هذه الصفات الفرديَّة عند الشخص الواحد بالتوازي مع بعضها، فقد يتميَّز أحدهم بمَلَكةٍ خطابيَّة لكن طبيعته الخجولة أو غير الاجتماعية تمنعه من مشاركتها مع الآخرين، وبالتالي قد لا تبرز موهبته أو تبقى مكتومة لمرحلةٍ متأخرة من حياته، وفي مثل هذه الحالة قد يبدو أنَّ الموهبة لم تكن موجودة أصلاً، إذ يصعب اكتشافها وهي غير ناضجة ودون اكتمالها بالصفات الفرديَّة الأخرى التي يتطلَّبها تكوين الموهبة.
على أن الاعتراف بالدور الجوهريّ للموهبة في اكتساب المهارات لا يعني أنَّ مصدرها يقتصر – ببساطة – على الجينات التي نرثها عن أمهاتنا وآبائنا، بل إن النظرة العلميَّة حول الجينات والمهارة اختلفت كثيراً في السنوات الأخيرة، فالأبحاث تميل إلى أنَّ الجينات ليست عاملاً حاسماً أو ثابتاً وإنَّما هي عُرضة للتغير والتطور استجابة للظروف التي نمرُّ بها. يقول عالم الأحياء في جامعة كامبردج باترك بيتسون: «يبدأ الإنسان حياته وجيناته مستعدّة للتطور في اتجاهاتٍ شتى، والذي يُقرِّر أي واحد من هذه الاتجاهات ستسلك جيناته فيما بعد هو البيئة التي تُحيط به والطريقة التي تؤثر بها عليه». لم تأتي وجهة النظر هذه من نظريَّات بحتة، بل أخرجها طيفٌ كبيرٌ من التجارب العلمية مُنذ خمسينيات القرن المنصرم. فقد أظهرت واحدة من هذه التجارب، وهي منشورة سنة 1958، أنَّ الفئران المنحدرة من سلالات جينيَّة شديدة الذكاء قد يظهرُ ذكاؤها عادياً (مقارنةً بالفئران الأخرى) عندما تنتقلُ من بيئة لأخرى.

لا بُدَّ وأن الجينات تؤدي دوراً ذا أهمية كبيرة في اكتساب الخبرات والمهارات، لكنَّها هي أيضاً محض جزء من عمليَّة مُعقَّدة تجتمع فيها عوامل كثيرة، ويُمكن النظر إليها كمحض صفة بشريَّة أخرى لها القدرة على التغير مع مرور الزمن. على أيِّ حال، ليس من الصَّحيح النظر إلى الموهبة والممارسة على أنَّهما فكرتان متناقضتان، فهُما – على العكس تماماً – مُكمِّلتان لبعضهما ولا قيمة تذكر لإحداهما دون الأخرى. ومع أنَّ تأثير الموهبة والممارسة على مهارات الناس قد يختلف وقد تتغيَّر وجهة نظر العلم حولها باستمرارٍ على مرِّ السنوات القادمة، إلا أنَّ الواضح أن كلاهما له دورٌ في النجاح. إنَّ إتقان البشر لمهارة ما يتطلَّب اجتماع عوامل كثيرة جداً، وحتى مع الموهبة العالية والتدريب الجيِّد يُمكن لنقص الحافز والرَّغبة بالتعلُّم أن يتكفَّل بإلغاء منافع هذين العاملين، بل وفي مُعظم الحالات قد يقضي انعدام التشجيع الإنساني على كلّ موهبة.
لا يولد البشر بقدراتٍ متساوية بالتأكيد، لكنهم ليسوا محكومين بما يولدون عليه، فكل شخصٍ له إمكانات خاصَّة به وفرصة لصناعة ذاته بعمله الشاق. ومع أنَّ الجينات الموروثة والموهبة الفطرية قد يؤثران بدرجةٍ عالية على فرص الناس في الحياة، إلا أنَّهما ليسا كفيلين بتقرير مصير ولا حياة أي شخص. ومثلما أن الأشخاص الذين ينعمون بمواهب استثنائية نادرون جداً في عالمنا، فإنَّ من لديهم الاستعداد لإفناء ساعات وسنوات طويلة بالعمل الشاق وبناء المهارة من العدم نادرون جداً أيضاً ولهُم مكانهم المُميَّز في هذا العالم. قد لا يولد جميع الناس وأمامهم طريق سهلٌ للنجاح، لكن لا أحد تقريباً يُولد على هذه الحال، فكلُّ من حقَّقوا إنجازات كبيرة في تاريخ البشرية لم يصلوا إليها إلا بجُهدٍ عظيم.


Comments 5
أتمنى لو أرفقت المقالات التي تحدثت أنك قرأتها في مقالتك هذه مشكورًا.
التدوينة فيها عددٌ جيّد من الروابط، هل تقصد مقالة مُعيّنة أشرتُ إليها؟
“ادفتُ منذ مدَّة مقالة تتحدث عن تخلُّف نظام التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدعو إلى إعادة هيكلته ليفتح مجالاً أكبر لإبراز مواهب الطلاب صغار السِّن، والتي…” هذه إن تكرمت.
في الحقيقة كان ذلك مُنذ زمن وقرأت وقتها العديد من المقالات عن الموضوع لذا يصعبُ علي العثور عليها بالتحديد، لكن هذه واحدةٌ من المقالات الجيدة التي كنت أقرؤها في تلك الفترة: http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2013/10/my-daughters-homework-is-killing-me/309514/
Pingback: لماذا لا يرغبُ طلبة الجامعات بالتعلّم؟ – مدونة عبَّاد ديرانية